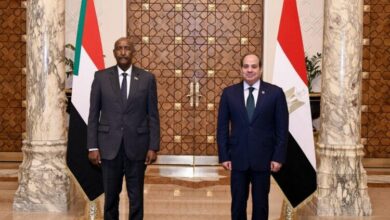بالامس عطلت “أبوظبي” بواسطة مليشياتها في الجسد السوداني احدى رئتيه الاقتصادية، حقول النفط في غرب كردفان. فاقتصاد الدولة الذي يترنح أصلاً تحت ثقل الحرب يدخل بذلك طوراً جديداً من الاضطراب؛ إذ تنخفض الإيرادات العامة في الوقت ذاته الذي ترتفع فيه كلفة معركة التحرير الوطني.
ومنذ ١٥/ابريل، تآكلت قدرات الدولة الريعية، وانهار السوق وتدمرت الاصول وتلاشت رؤوس الاموال. وبعد الافاقة من صدمة الحرب، بدأ يتحرك الناس نحو ابتكار سبل للبقاء، فصنعوا اقتصاداً موازياً لا يقوم على الامتيازات ولا على الاحتكارات، بل على قانون الضرورة. السودانيون اليوم يصنعون هذا الاقتصاد من رحم الخراب، يبحثون عن رزق يعوض خسائر الحرب حتى ينهضوا من تحت الركام بعرق الجبين.
ان تجارة “الطبالي” ليست مشروعاً استراتيجياً ولا مسعى للثراء الفاحش. هي محاولات فردية متواضعة برؤوس اموال صغيرة لا تتجاوز عشرة الاف دولار، لكنها في مجموعها تمثل تدفقات نقدية صغرى ساهمت في تنشيط السوق ورفدت الخزينة العامة بما يقارب (٣٨) مليار جنيه يومياً من الرسوم والجمارك. اي انها مصدر ايراد مستقل للدولة في زمن تراجعت فيه الايرادات الكبرى.
فما الذي يضير الدولة وهي تواجه حرباً مصيرية في الارض والاقتصاد ان يبتكر مواطنوها بجهدهم مصادر رزق، ولماذا تعامل الحكومة هذا النشاط كتهديد؟ ما الفلسفة التي تجعل السلطة تغلق هذا الصنبور الصغير بينما انابيب مافيا الوقود والذهب تضخ ملايين الدولارات في شرايين تماسيح الاقتصاد الطفيلي ارباحاً طائلة من التهرب الضريبي؟
واي منطق اخلاقي او اقتصادي يبرر ان تحتجز بضائع الناس في ميناء عثمان دقنة لاشهر حتى تتلف وكأن الدولة تمارس ضدهم عقاباً لا تفسير له الا خلل في الرؤية او استعلاء السلطة على المجتمع المنتج؟.
ان منع تجارة “الطبالي” لا يمكن فهمه الا بوصفه سياسة قصيرة النظر. ففي اللحظة التي كان ينبغي فيها للسلطة ان تكون ميسراً لحركة الرزق تحولت الى عائق، وحين تمنع موارد الناس الصغيرة بينما تنهب موارد الدولة الكبيرة تبدأ الفجوة بين الدولة والمجتمع في الاتساع حتى يصبح رأبها عسيراً.
محبتي واحترامي